
حين يصبح الحياد انحيازا.. هل لا يزال القانون الدولي حياديا؟

في كل أزمة دولية كبرى، يُعاد استدعاء القانون الدولي كمرجعية أخلاقية وتنظيمية، يُفترض أنها فوق السياسات، وفوق الحسابات، وفوق موازين القوة.
لكن حين تتكرر الأزمات، وتُقارن المواقف، وتُفحص القرارات، يطرح العقل سؤالا منطقيا: هل لا يزال القانون الدولي حياديا فعلا؟
اقرأ أيضا
list of 4 itemsend of list
أم أن ما نراه من “الحياد” في نصوصه يُترجم عمليا إلى انحياز صامت، أو حياد ينطق حين يشاء، ويصمت متى اقتضت المصالح؟
ولذلك فإن سؤلا يطرح نفسه، وهو: لماذا يُفترض أن يكون القانون الدولي محايدا؟
القانون الدولي والتباين بين النصوص والتنفيذ
القانون الدولي في جوهره؛ هو منظومة من المبادئ والاتفاقيات التي تنظّم علاقات الدول، وتحمي السلم العالمي، وتضبط قواعد النزاع والاحتلال، وتحمي المدنيين في أوقات الحرب.
وقد تأسس القانون الدولي -خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية- على فكرة أن البشرية بحاجة إلى قواعد مشتركة، لا تكون خاضعة لمزاج المنتصرين أو نزوات الأقوياء.
ووفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، فإن من أبرز أهداف المنظمة “حفظ السلم والأمن الدوليين”، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والقانون الدولي.
كما أن اتفاقيات جنيف لعام 1949، وخصوصا الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، تُلزم أطراف النزاع بتجنّب استهداف المدنيين، وضمان سلامتهم، وتوفير الحماية للمنشآت الطبية والإنسانية.
لكن مع مرور الزمن، بدأ التباين يتسع بين “النصوص” و”التنفيذ”، وبين المبادئ المعلنة والمواقف الميدانية، وبين النظرية والواقع.
وبات كثير من الباحثين في العلاقات الدولية يتحدثون عن القانون الدولي، لا كمنظومة قواعد مجردة، بل كمساحة للصراع بين تفسيرات متعددة، تتحكم فيها المصالح السياسية والنفوذ داخل المؤسسات الدولية.
ولذلك، فإن الحياد المفترض للقانون الدولي صار مفقودا في الصراع بين المبادئ والممارسة.
وحتى يكون القانون الدولي حياديا فإن هذا يعني: أن يتم التعامل مع كل انتهاك وفقًا للقيم نفسها، بغضّ النظر عن الفاعل، وهو ما يعني أن يُحاسَب المعتدي، حتى لو كان من القوى الكبرى، وأن تُحمى حقوق الإنسان، دون النظر إلى جنسيته أو خلفيته.
لكن الواقع العملي يُظهر أن هذه الشروط نادرا ما تتحقق على أرض الواقع.
في ملفات دولية عديدة لا حصر لها، لا يتم التعاطي مع الوقائع بناء على حجم الانتهاك، بل بناءً على هوية المنتهِك والمنتهَك.
وبالتالي، فإن الحياد الذي يُفترض أن يحكم تطبيق القانون الدولي، يصبح مشهدا انتقائيا تُسلط فيه الأضواء على مناطق، وتُغضّ الأبصار عن مناطق أخرى.
مظاهر الحياد المنحاز في القانون الدولي
يتجلى الحياد المنحاز للقانون الدولي في مظاهر عدة:
ازدواجية المعايير في المحاسبة، حيث نجد بعض الدول تُقدم إلى المحاكم الدولية بسرعة خاطفة، في حين تبقى أخرى محصّنة، رغم توفُّر الأدلة والبلاغات، وتمثل الحالة الإسرائيلية نموذجا صارخا يهز أركان الشرعية الدولية.
كما تظهر ازدواجية المعايير أيضا في تعامل المجتمع الدولي مع ملفات أخرى، مثل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وفي التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، كما أثار الصراع في أوكرانيا منذ 2014، وتصاعد التوترات بعد الغزو الروسي في 2022، جدلا واسعا حول مدى حيادية تطبيق القانون الدولي.
ويتجلى ذلك أيضا في الخطاب الرسمي للمؤسسات الدولية، الذي غالبًا ما يلتف على الانتهاكات الصريحة باستخدام عبارات ضبابية كـ”نعبر عن القلق” و”ندعو إلى ضبط النفس”، دون تسمية المعتدي أو الإشارة إلى مسؤولية قانونية واضحة.”
ويعد التأخير في إصدار المواقف أحد أبرز المظاهر التي تقوض حياد القانون الدولي. فالمؤسسات الدولية قد تستغرق أشهرا، بل وسنوات قبل أن تُدين انتهاكا واضحا، والسبب في أحيان كثيرة ليس نقص الأدلة، بل التوازنات السياسية التي تمنع تطبيق القانون.
كذلك فإن تسيس التحقيقات يُعد وجها آخر لفقدان الحياد في القانون الدولي، ويتجلى ذلك في اللجان الدولية التي تُشكل أحيانًا بطريقة تُرضي جميع الأطراف، لا بهدف كشف الحقيقة فقط، ما يؤدي إلى تمييع النتائج أو إخراج تقارير ضعيفة.
المؤسسات القانونية رهينة النفوذ السياسي
رغم الاستقلال الاسمي للمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، إلا أن واقعها يُظهر أنها لا تعمل في فراغ، بل ضمن بيئة سياسية مشحونة ومترابطة.
فبالنسبة للتمويل، فإن جزءا كبيرا من ميزانيات هذه المؤسسات يأتي من الدول الكبرى.
ومن المفارقات أن التعيينات في المؤسسات القانونية الدولية تعكس بوضوح توازنات القوى، وغالبًا ما تكون مشروطة بترضيات سياسية.
كما أنه في حال صدور قرارات من المؤسسات القانونية الدولية، فإنها تبقى رهينة لإرادة مجلس الأمن، حيث تمتلك بعض الدول حق النقض (الفيتو)، الذي يُعد المقوض الأول للعدالة في المنظومة الدولية.
وهكذا، تتحول المحاكم أحيانا إلى كيانات رمزية أكثر من كونها أداة رادعة، وتصبح بعض المبادئ الجميلة في النصوص القانونية محصورة في خانة المثاليات، بعيدا عن الواقع.
وهنا تتجلى المفارقة، بين كون القانون الدولي كأداة ردع، وكونه بات أداة للتبرير السياسي، إذ إنه في أحيان كثيرة، يُستخدم القانون الدولي لا لردع المعتدي، بل لتبرير الأفعال بعد وقوعها.
فنجد النصوص المتعلقة بالدفاع عن النفس تُفصل لتشمل الهجوم الاستباقي، كما تُستخدم “الحماية الإنسانية” كذريعة للتدخل العسكري، حين يكون الأمر في مصلحة قوى محددة، وتُهمَّش الانتهاكات الموثقة، فقط لأن المعتدي من الحلفاء.
بهذه الممارسات، يتحوّل القانون من “مرجع حيادي” إلى أداة تُشرعن ما سبق اتخاذه من قرارات سياسية، بدلا من أن تحكمها.
هل فقد القانون الدولي مصداقيته؟
القول بأن القانون الدولي فقد مصداقيته تمامًا فيه قدر كبير من التبسيط؛ لأنه لاتزال هناك مساحات حقيقية يعمل فيها بفاعلية، منها: في فض النزاعات الحدودية، وفي بعض ملفات حقوق الإنسان، وفي الجوانب الإنسانية.
لكن، يظل التحدي الأكبر للقانون الدولي في الملفات الحساسة ذات الطابع السياسي والعسكري، حيث تتضارب المصالح، وتظهر حقيقة “الحياد المنحاز”.
إن فقدان الثقة في المؤسسات الدولية شعبيا ونخبويا لا يعني بالضرورة سقوطها، لكنه يشير إلى أزمة متزايدة في شرعية الأداء، لا في شرعية المبدأ.
ورغم اختلالات القانون الدولي فإنه يجب التمسك به، لأن البديل عنه هو الفوضى. ولأن نقد القانون الدولي لا يعني نفي ضرورته، بل هو دعوة لإصلاحه، وتفعيل أدواته، وتعزيز استقلاله عن النفوذ السياسي.
كما أن استخدام أدوات القانون الدولي بذكاء، يمكن أن يُحرج القوى المتجاوزة، حتى وإن لم يُوقفها بالكامل.
إن المعارك القانونية لا تُقاس فقط بنتائجها، بل بتراكم الملفات، وكسب الرأي العام، وبناء سردية قانونية موازية تفضح الازدواجية.
حياد لا بد أن يُستعاد
قد يكون القانون الدولي اليوم حياديا في شكله، لكنه منحاز في أدائه.
وهذا الانحياز لا يعني وجوب هدمه، بل العمل على فضحه، والضغط لإصلاحه، وفرض التوازن داخله عبر التحالفات، والنضال السلمي المستمر.
في عالم لا تعصمه القوة من الفوضى، يبقى القانون رغم هشاشته أحد الأدوات القليلة التي تمنح الأمل في تحقيق العدالة وإن تأخرت.
لكن هذا الأمل لا يتحقق بالصمت، بل بالمطالبة الدائمة بأن يُعامل الجميع وفق المعيار نفسه، دون تمييز في الدم، ولا استثناء في العقاب.






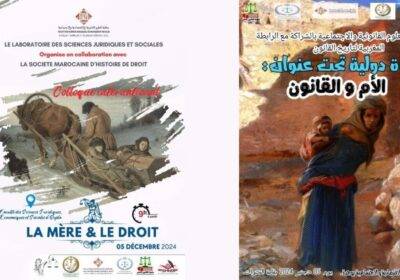
No Comment! Be the first one.